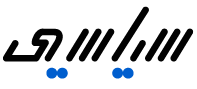بقلم سعد الدين ابراهيم: ألم يئن الأوان لرد اعتبار هشام جنينة؟

لا تزال هيئة الرقابة الإدارية تُطالعنا كل يوم بأخبار القبض على أحد المسؤولين فى تلك الوزارة أو هذه المؤسسة العامة فى الدولة المصرية، بتهمة الفساد. ويكون ذلك عادة فى حالة تلبس، أى أثناء تلقى المسؤول لرشوة نقدية أو عينية. هذا فضلاً عن نوع فريد فى مجتمعنا هو الرشوة الجنسية.
وقد أحصيت ما نشرته الصُحف، نقلاً عن جهات الرقابة الإدارية، وتلك التى تتمتع بحق الضبطية القضائية فى عام 2016 وحده، ووجدته يتجاوز المليار جنيه، رشاوى نقدية فقط. ناهيك عن الرشاوى العينية، التى لا سبيل لديّ لترجمتها إلى قيمة نقدية، وإن كان ظاهر الحال يُشير إلى تجاوزها ما يُساوى مليارى جنيه مصرى. أى أننا نتحدث عن حجم فساد يتجاوز ثلاثة مليارات جنيه فى بند واحد فقط وهو الرشوة.
فمن المعروف أن للفساد ألف وجه ووجها آخر، بما فى ذلك المحسوبية، والواسطة، واستغلال النفوذ. وقد أصبح هناك علم اجتماعى مُتخصص لدراسة الفساد (Corruptology). كما ظهرت فى السنوات العشرين الأخيرة منظمات دولية لدراسة الفساد، ربما كان أهمها منظمة الشفافية الدولية Transparency International. وتنشر تقريراً سنوياً عن حالة الفساد فى العالم، بما فى ذلك مؤشرات مختلفة لأنواع الفساد، ثم مؤشر عام مُركب للفساد، ويتم عادة ترتيب دول العالم تنازلياً على ذلك المؤشرـ من الأقل فساداً، وهى عادة كندا وسِنغافورة والدول الإسكندنافية، إلى الأكثر فساداً، ومعظمها فى بُلدان العالم الثالث، وخاصة بُلدان القارة الأفريقية.
المُهم لموضوعنا، هو أن مصر وسوريا واليمن كانت ضمن الرُبع الأكثر فساداً، طبقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية، خلال السنوات العشرين الأخيرة (1980-2015).
وفى ضوء تقارير الشفافية الدولية المُحايدة، وما نشرته وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن مؤسسات رقابية، فإن ما كان قد صرّح به المُستشار هشام جنينة عن حجم الفساد فى مصر، خلال خمس سنوات (2005-2010) وتجاوز سُتمائة مليون جنيه، لم يكن ينطوى على أى مُبالغة أو افتراء! بل أغلب الظن أنه كان أقل من الحجم الحقيقى، أى الذى لم تتوفر عنه مصادر موثوقة يرضى عنها ضمير قاض جليل، مشهود له بالخبرة والنزاهة. فإذا كانت الرقابة الإدارية قد ضبطت فى حالة واحدة، لأحد العاملين فى مشتروات مجلس الدولة، مبالغ نقدية بعُملات مختلفة فى منزله، تُقدّر بحوالى مائة وخمسين مليون جنيه. هذا فضلاً عن القبض منذ عدة سنوات عن أحد الوزراء مُتلبساً باستلام رشوة نقدية، مُقابل منحة تسهيلات لحصول بعض المواطنين على مئات الأفدنة من أملاك الدولة بسعر بخس، وأقل كثيراً من قيمتها السوقية.
وفى ضوء كل ما تقدم، أعتقد أنه قد آن الأوان لرد الاعتبار للمستشار الجليل هشام جنينة، الذى كان قد أطلق صافرة الإنذار الرسمية الأولى حول حجم الفساد، خلال خمس سنوات. وكان الرقم صادماً، فى حينه. وأدى إلى صدور مرسوم رئاسى بإحالة الرجل من منصبه. وكالعادة قامت أجهزة الإعلام المُنافقة لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالهجوم على الرجل، واغتياله معنوياً، وعزله من منصبه وإحالته للتحقيق، مع إيحاءات بأنه كان إخوانياً أو مُتعاطفاً معهم!
صحيح أن سُلطات التحقيق قد برّأت هشام جنينة فيما بعد. ولكن هذه البراءة لم تحظ بنفس عناوين وسائل الإعلام الرسمية التى كانت قد نهشت سُمعة الرجل زوراً وبُهتاناً.
ورغم أننى لا أعرف المستشار هشام جنينة، ولم أحظ أبداً بلقائه شخصياً، إلا أن أحد أسباب تعاطفى معه هو إحساس أى مُثقف يحترم شرف الكلمة، وينأى بنفسه عن أن يكون شيطاناً أخرس.
أما السبب الثانى فهو أننى تعرّضت لموقف مُماثل منذ سبعة عشر عاماً، فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مُبارك، شفاه الله، وفرّج كُربته. ولم أكن قد اقترفت ذنباً إلا التنبيه عن خطر توريث منصب رئيس الجمهورية، من الأب إلى الابن، أسوة بما كان قد حدث بالفعل فى سوريا، حيث تولى نجل الرئيس الراحل حافظ الأسد، ابنه بشّار الأسد. وهو ما انطوى على حُكم أسرة واحدة، امتد وقتها ثلاثين سنة (ووصل الآن أكثر من أربعين عاماً)، وهو ما أطلقت عليه فى حينه مُصطلح الجملوكيات العربية. والجملوكية كانت تعبيراً عن حالة فريدة أبدعها العرب، وفيما بعد الكوريون الشماليون، لوصف نظام سياسى، جمهورى غير وراثى دستورياً. ولكنه فى الواقع وراثى شبه ملكى. ومن هنا اشتقاق ذلك المُصطلح الجديد على اللغة العربية، لوصف واقع الحال العربى الفريد، والذى كانت أربع بُلدان عربية تتجه فيه نفس اتجاه سوريا.
فقد كان صدام حسين فى العِراق يُعدّ نجله عُدّى لوراثة المنصب الرئاسى. وكان مُعمّر القذافى، فى ليبيا، يُعد ابنه سيف الإسلام لتولى الرئاسة من بعده. ونفس الشيء مع على عبدالله صالح، وابنه أحمد، فى اليمن. وكان الشىء نفسه مُتوقعاً فى تونس، على يد رئيسها المُخضرم وقتها، زين العابدين بن على، الذى لولا أنه لم يُنجب أولاداً ذكوراً، وأقنعته زوجته، بأن يصطفى أحد أشقائها لذلك، لولا أن حادثاً عارضاً فى بلدة بوعزيزى بين إحدى الشخصيات الأمنية، وأحد الباعة الجائلين أدى إلى انفجار غضب شعبى، تحوّل فى خلال ساعات إلى احتجاجات شبابية فى معظم المُدن التونيسية، وفى غضون الأيام العشرة التالية تحوّلت تلك الاحتجاجات الشبابية إلى انتفاضة شعبية عارمة، شاركت فيها عناصر من كل الطبقات، وشملت بقية أنحاء تونس. وكان اشتراك الاتحاد العام للشغل فى الأيام الأخيرة من تلك الانتفاضة، حاسماً لإقناع الرئيس زين العابدين بأن نهايته أصبحت وشيكة، حيث إن ذلك التنظيم النقابى هو أحد وأهم الأعصاب الحساسة للمجتمع التونسى. ثم تدهورت الأمور بسرعة حينما رفضت الشُرطة التونيسية فتح النار على المُتظاهرين والمُحتجين. وكانت الضربة الأخيرة والقاضية حينما رفضت قوات الجيش التونسى تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية بالنزول إلى الشوارع.
حينها أدرك زين العابدين بن على أن تلك هى النهاية فأذعن، وتنازل عن السُلطة، وغادر تونس إلى الجارة ليبيا، حيث استقبله رئيسها مُعمر القذافى لعدة ساعات، إلى أن تواصل زين العابدين بن على مع الأسرة المالكة السعودية، التى وافقت على استضافته فى المملكة، كلاجئ سياسى.
كل ذلك كان مُقدمة طويلة لتأكيد معنيين، الأول، هو مقولة المُفكر العربى الإسلامى عبدالرحمن ابن خلدون، بأن الفساد يؤذن بخراب العمران. والثانى أن ما فعله المستشار هشام جنينة هو إطلاق صُفّارة إنذار مُبكرة بنفس الشىء. ولم يستحق ما ناله بسبب ذلك من أذى السُلطة وتشويه السُمعة. لذلك، إذا كان النظام جاداً بالفعل فى مُحاربة الفساد، فعليه أن يردّ الاعتبار للمستشار هشام جنينة.
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.. وعلى الله قصد السبيل.