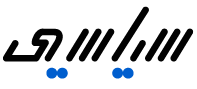بقلم فهمي هويدي: تفكير آخر فى فتنة القضاء المصرى

أيكون اللعب الحاصل فى ملف القضاة هذه الأيام حلقة فى مسلسل ترتيب الأوراق قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة (عام ٢٠١٨)؟
(١)
أتحدث عن مفاجآت الساحة القضائية التى باغتت المصريين فى الأسابيع الأخيرة، حين فوجئنا ذات يوم بوكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان يقدم مشروعا جديدا للسلطة القضائية يقلب نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية. بحيث يلحقها عمليا برئاسة الجمهورية. ذلك أن المتعارف عليه والمعمول به منذ أن صدر قانون استقلال القضاء فى عام ١٩٤٣، أن تلك الهيئات هى التى تختار رؤساءها. لكن الاقتراح المقدم دعا إلى تعديل العملية بحيث يتولى رئيس الجمهورية القرار، إذ يختار واحدا من ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية. ثم فوجئنا بأن الاقتراح عرض على اللجنة التشريعية، التى وافقت عليه قبل الاسترشاد برأى القضاة، وخلال أربع وعشرين ساعة عرض الأمر فجأة على مجلس النواب دون أن يكون مدرجا على جدول الأعمال، ولأن رئيس المجلس متخصص فى تمرير رغبات السلطة التنفيذية، منذ قام بتمرير ٣٤٠ قانونا أصدرها رئيس الجمهورية خلال ١٥ يوما بمتوسط ٢٠ قانونا فى اليوم الواحد، فلم يكن مستغربا أن تتم إجازة المشروع فى نفس الجلسة. وهو ما أثار ثورة القضاة الذين رفضوا المشروع وتكتلوا لمعارضته. وحدثت بعد ذلك مفاجأة أخرى بدت تصعيدا للمواجهة بين المجلس والقضاة، إذ نشر يوم الجمعة ٣١/٣ أن ثمة مشروعا يجرى إعداده للعرض على البرلمان يدعو إلى خفض سن إحالة القضاة إلى المعاش بحيث ينزل من ٧٠ عاما إلى ستين عاما على مرحلتين، وذكرت جريدة «الشروق» أن فكرة خفض سن المعاش جاءت بعد رفض القضاة للقانون سيئ السمعة الذى أصدره البرلمان، الأمر الذى يعنى أنها بمثابة عقاب للقضاة ولى لأذرعهم.
فى أجواء التوجس واهتزاز الثقة، تلقى الجميع رسالة أخرى فى الوقت نفسه. إذ فى حين نشرت «الشروق» خبر الاتجاه إلى تخفيض سن الإحالة إلى المعاش، الذى يؤثر على دخول أكثر من ألفى قاض، فإنها أبرزت على صفحة داخلية الرسالة الأخرى. فذكرت أنه تقررت إحالة اثنين من كبار القضاة إلى لجنة التأديب والصلاحية يوم ٢٤ إبريل الحالى بما يعرضهم لعقوبات متعددة تتراوح بين اللوم أو النقل لوظيفة غير قضائية أو العزل والإحالة إلى المعاش. القاضيان هما المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. و«التهمة» الموجهة إليهما هى اشتراكهما مع الحقوقى نجاد البرعى فى إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب(!) ــ خلاصة رسالة الإحالة كانت كالتالى: من اعترض على التعذيب وسعى إلى وقفه سيعاقب مهما علا مقامه. أما معارضو قانون السلطة القضائية فلن يكونوا بمنأى من العقاب.
(٢)
المفاجأة أثارت أسئلة عدة. أحدها يتعلق بالجهة التى حركت العملية، خصوصا أن الجميع يعرفون أن البرلمان شكلته جهات من خارجه. الثانى ينصب على الهدف من العملية، الثالث يخص أسباب تجاهل البرلمان للهيئات القضائية، وإخفاء أمر المشروع عن أعضاء البرلمان ثم مفاجأتهم بعرضه عليهم والتصويت الفورى عليه، تم تفسير الاستعجال غير المبرر فى تمريره.
المتابعون للموضوع استحضروا قصة القانون، الذى خول للرئيس عزل رؤساء الهيئات «المستقلة»، وسمى آنذاك قانون جنينة، باعتبار أنه استهدف إقصاء المستشار هشام جنينة الذى رأس جهاز المحاسبات ولم يكن مرضيا عنه آنذاك (عام ٢٠١٦). وخلصوا إلى أن السلطة التنفيذية أزعجتها الأحكام التى صدرت بخصوص جزيرتى تيران وصنافير التى قررت مصريتهما وأبطلت الاتفاق الذى وقعته الحكومة بخصوصهما. لذلك فإنها أرادت أن تقطع الطريق على اثنين من القضاة المشكوك فى انصياعهما للهوى السياسى، بعدما حل عليهما الدور فى رئاسة بعض الهيئات القضائية. الاثنان هما المستشار يحيى دكرورى الذى أصدر حكم الإدارية بخصوص الجزيرتين وهو مرشح لرئاسة مجلس الدولة. والثانى المستشار أنس عمارة المرشح لرئاسة محكمة النقض. وهو من دعاة استقلال القضاء، وقد حسب عليه أنه تلميذ للمستشار حسام الغريانى رئيس النقض الأسبق، وهو من غير المرضى عنهم بسبب انحيازه لاستقلال القضاء ورئاسته للجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور أثناء حكم الإخوان. وسمعت شائعات فى أوساط القضاة ذكرت أن رئاسة المستشار أنس لمحكمة النقض قد تسهم فى إزالة العقبات التى وضعت أمام إنصاف ١٤ قاضيا من دعاة الاستقلال سبق فصلهم من وظائفهم.
أضيف من عندى سببا آخر قد يدفع الأجهزة إلى إقصاء المستشار المرشح لرئاسة النقض هو الخشية من أن تقوم المحكمة بإبطال أغلب أحكام القضايا السياسية التى صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة وهى التى تمت الإدانة فيها بناء على تحريات الشرطة، باعتبار أن للنقض حكما صريحا لا يعترف بالتحريات كدليل للإدانة ما لم تؤيدها شهادات أو أدلة أخرى. وهناك سبب آخر لإبطال الأحكام التى صدرت فى قضايا نظرت فى مقر أكاديمية الشرطة باعتباره مكانا غير محايد، وكان رئيس النقض الحالى قد وجه خطابا بهذا المعنى إلى وزير العدل.
سواء لبعض هذه الأسباب أو كلها، فإن الجهات التى حركت المشروع أرادت أن تحسم المسألة بحيث يختار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية قبل ٣٠/٦ القادم، وهو الموعد الذى تنتهى فيه المدة القانونية للرؤساء الحاليين، كما تنتهى فيه دورة مجلس النواب لتبدأ عطلته فى ١/٧.
(٣)
تغول السلطة التنفيذية على القضاء المستقل سبقه تغول آخر على مجالس الإعلام الذى يفترض أن يكون مستقلا. وكنت قد فصلت فى هذه النقطة فى مقالة سابقة نشرت فى العاشر من يناير الماضى (٢٠١٧)، وكان عنوانها «مصر من الضيعة إلى الشخصنة». وخلاصة ما ذكرته أن عبثا تم فى إعداد قانون الإعلام الموحد، حوله إلى قانونين، لتنظيم عمل الكيانات الصحفية الثلاث التى نص عليها دستور ٢٠١٤، وهذه الكيانات اعتبرت مجالس وطنية «مستقلة». لكن رؤساءها يختارهم رئيس الجمهورية من بين من ترشحهم قواعدهم. كما يختار الرئيس ثلاثة أعضاء فى مجلس إدارة كل كيان. وذلك يعنى أن إدارة الشأن الإعلامى والصحفى لم تعد متروكة لقواعد العاملين فى المجالات الإعلامية، من صحافة وتليفزيون وإذاعة.
بشكل مواز لإلحاق الكيانات الصحفية بالرئاسة من الناحية القانونية، فإننا نلحظ تدخلا مباشرا من حانبها فى ممارسات المجال الإعلامى، وكانت الصحافة القومية تعبر عن الشكل التقليدى لذلك التدخل. وهو ما تطور خلال السنوات الأخيرة بحيث تمثل فى المشاركة فى القنوات الخاصة، وانتهى بإطلاق قنوات تليفزيونية تابعة للسلطة بصورة مباشرة.
غنى عن البيان أن تدخلات السلطة وهيمنتها ليست مقصورة على القضاء والإعلام، لإننا نلحظ ذلك فى أهم الأنشطة المجتمعية من قانون الجمعيات الأهلية إلى قانون الجامعات، مرورا بالمجالس الشعبية والإدارة المحلية. وإذا أضفنا إلى ذلك أن البرلمان أصبح ذراعا للحكومة وليس رقيبا عليها كما ينص الدستور، ووضعنا فى الحسبان القانون الذى أعطى للرئيس حق عزل رؤساء المجالس المستقلة، فذلك يعنى أنه لم تعد فى مصر مؤسسة تتمتع باستقلال حقيقى، كما يعنى أن المجتمع فقد مقومات عافيته ودخل فى عصر تأميم المجال العام.
من النتائج الخطيرة التى ترتبت على ذلك الوضع أن رئيس الدولة أصبح محملا بكم هائل من المسئوليات التنفيذية، التى تفوق جميع البشر. لذلك فمن الطبيعى أن تصبح الأجهزة الأمنية طرفا يعول عليه فى إصدار القرارات المتعلقة باختيار القيادات.
(٤)
فى العصر الحديث فإن السلطة إذا أرادت أن تحكم قبضتها على المجتمع فإنها تحقق مرادها من خلال أربعة عناصر هى الجيش والشرطة والقضاء والإعلام. الجيش والشرطة يمثلان القوة المادية، والقضاء يوفر الغطاء القانونى. أما الإعلام فقد ظل سلاح التعبئة والتبرير والتسويق. وإذا كان الجيش والشرطة يمثلان القوة المادية فإن القضاء والإعلام ظلا يمثلان القوة الأخلاقية والمعنوية. واحتل القضاء موقعا خاصا باعتباره حارسا لقيم العدل والحرية. وبسبب ذلك الموقع الفريد، فإن الموقف من القضاء ظل دائما معيارا لمدى رسوخ قوائم العدل والحرية فى المجتمع. ونحن نشهد فى الوقت الراهن مثلا كيف يقود القضاء حملة التصدى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قراراته التى تنتقص من قيم الحرية فى المجتمع.
هذه النقطة الأخيرة وثقها وفصل فيها المستشار طارق البشرى فى كتابه «القضاء المصرى بين الاستقلال والاحتواء» الذى أعادت طبعه أخيرا «دار البشير». إذ بين كيف أن ثورة يوليو ١٩٥٢ أحاطت بالقضاء وأبعدته عن التأثير فيما ترى الدولة أنه يمس سياستها. إذ لجأت إلى منع التقاضى فى المسائل التى اعتبرتها ذات أهمية سياسية، كما أنشأت محاكم خاصة لنظر القضايا ذات الحساسية السياسية بالنسبة للنظام الجديد (محاكم الثورة مثلا). وفيما عدا بعض الاستثناءات فقد ترك القضاء ورجاله على حالهم، رغم الصدام الذى حدث مع نظام عبدالناصر فى عام ١٩٦٩، وأفضى إلى ما سمى بمذبحة القضاة. لكن الأمر اختلف فى المرحلة الساداتية التى بدأت فى عام ١٩٧٠ وما تلاها. إذ بدأت السلطة فى العبث بالقضاء بعدما ضاقت به (فى الفترة بين عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٠ حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجالس الشعب الأربعة التى شكلت خلالها). ولجأت فى عبثها إلى الإبقاء على هياكل القضاء مع تفريغه من مضمونه (أشرف القضاء على الانتخابات التى تم تزويرها). وهو ما حدث مع الأحزاب التى سمح لها بالتعددية، إلا أن دورها بات منعدما.
فى الوقت الراهن الذى تمت فيه عسكرة السلطة وأصبحت القوات المسلحة لأول مرة فى التاريخ المصرى تتصدر المشهد السياسى فإن خطوات التمكين ذهبت إلى أبعد. إذ بعد تذويب الفوارق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل الدور على السلطة القضائية، لكى تمضى على درب الإلحاق، وبعدما قطعت أشواطا عدة فى ذلك الاتجاه، اقتضى الأمر استكمال عملية الإلحاق من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
هذه الخلفية تسوغ لى أن أزعم بأن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ليس منفصلا عن الخطوات التى سبقته وجرى فيها إلحاق أهم مؤسسات المجال العام بالسلطة، وحين تتسارع تلك الخطى خلال العام الحالى الذى يسبق الانتخابات الرئاسية التى تحل فى العام المقبل، فإننا ينبغى أن نقرأ المشهد بعين أخرى. إذ حين يفضى كل ذلك إلى التمكين للسلطة وتأميم المجال العام فلا تفسير له إلا بحسبانه نوعا من ترتيب الأوراق وتأمين الفضاء الداخلى قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. وإذا صح ذلك فإنه يثير سؤالا كبيرا حول كيفية التعامل مع ملف الانقسام السياسى والحرب الأهلية الباردة الجارية منذ ثلاث سنوات فى بر مصر.