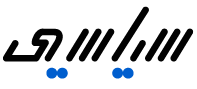بقلم زياد بهاء الدين: لماذا نعجز عن وقف انفلات الأسعار؟

الشائع بين الناس وفى وسائل الإعلام أن السبب وراء عاصفة ارتفاع الأسعار الممتدة منذ ما يقرب من العام هو قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الطاقة. وهذا صحيح لأنها كلها إجراءات ذات آثار تضخمية.
ولكنها ليست كافية وحدها لتفسير القفزات الهائلة للأسعار فى الفترة الأخيرة، بل إن هناك عوامل أخرى ساهمت فى تفاقمها، ومتعلقة بطبيعة الأسواق وبأدوات الدولة فى إدارتها.
فالمتفق عليه بين غالبية الاقتصاديين الجادين أن التضخم الذى شهدته الأسواق المصرية خلال الشهور الماضية لا يمكن تفسيره بمجرد زيادة تكلفة الاستيراد بسبب انخفاض سعر الجنيه أو ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، بل إننا حيال حالة من الانفلات فى الأسواق جعلت القفزات السعرية تتجاوز ما يمكن تفسيره اقتصاديا، خاصة بالنسبة للسلع والخدمات قليلة التأثر بسعر الدولار أو الوقود، وحتى مع الأخذ فى الاعتبار بما يسمى بالأثر الثانوى للتضخم.
وفى تقديرى أن جانبا رئيسيا من هذا الانفلات يرجع إلى طبيعة الأدوات التى تلجأ إليها الدولة لمحاولة ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاستغلالية. فالتفكير السائد فى المجتمع عموما لا يزال يفترض أن الأجهزة الحكومية يمكنها ضبط الأسواق بإحدى ثلاث وسائل: إما تحديد الأسعار جبريا وفرض الرقابة والعقاب على من يخالفها، وإما تدخل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لإتاحة السلع والخدمات الضرورية بأسعار مناسبة وتوزيعها مباشرة على الجمهور، وإما رفع سعر الفائدة المصرفية من أجل الحد من الطلب.
ولكن الواقع أن هذه الأساليب لم تعد مناسبة ولا فعالة بمفردها لوقف الفوضى فى الأسواق والانفلات فى الأسعار. فلا الدولة قادرة على فرض تسعيرة جبرية والاعتماد على مئات الآلاف من المفتشين والمراقبين لمتابعة كل الأسواق والمعاملات على نحو ما كان ممكنا حينما كان السكان أقل عددا والدولة هى المنتج الرئيسى والناس استهلاكها نمطى ومحدود.
ولا الاعتماد على توفير السلع والخدمات للجمهور مباشرة قابل للاستمرار لأن هذا التدخل ينبغى أن يكون فى الحالات الطارئة والاستثنائية فقط ولا يمكن أن يكون بديلا مستمرا للآليات المعتادة للإنتاج والبيع والشراء. ولا رفع سعر الفائدة كفيل بالحد من التضخم فى ظل انحسار الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادى.
البديل البديهى ــ والذى تطرقت إليه الأسبوع الماضى ــ هو زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وهو فى نهاية المطاف المخرج الرئيسى من أزمتنا الراهنة. ولكن إلى أن يتحقق ذلك فإن الدولة فى يدها أداة أخرى قلما تستخدمها للحد من فوضى الأسواق وانفلات الأسعار، وهى إتاحة الفرصة للمنافسة، والسماح لصغار المنتجين والموزعين بدخول السوق دون قيود أو تكاليف مبالغ فيها، والحد من قدرة أصحاب السطوة والنفوذ على استغلال الأوضاع الاحتكارية المتراكمة عبر السنوات، ووقف التغول البيروقراطى بدعوى مراقبة السوق وحفظ الأمن وحماية المستهلكين لأنه لا يحقق سوى عكس ذلك تماما، أى تمكين محتكرى توزيع وتجارة السلع والخدمات الضرورية من استغلال القيود والعوائق البيروقراطية للتحكم فى الأسعار والارتفاع بها بأكثر مما تفرضه المتغيرات الاقتصادية.
ويرتبط بما تقدم أن هناك حاجة ملحة لفتح المجال ليس فقط أمام صغار المنتجين والموزعين من القطاع الخاص، وإنما أيضا للجمعيات الأهلية والاتحادات التعاونية وروابط صغار المزارعين والمنتجين والتجار وجمعيات حماية المستهلكين وكل أشكال العمل الأهلى التى تساهم فى تجميع الموارد وحشد الجهود للاستفادة من آليات بديلة وشديدة الفاعلية فى الكثير من بلدان العالم للحد من انفلات الأسعار ومقاومة استغلال الشبكات الاحتكارية.
ولكن الواقع أن اندفاع الدولة لمحاربة وتقييد المجتمع المدنى المستقل، لأسباب سياسية، قد انسحب على كل أوجه النشاط الأهلى وحرم المجتمع من أحد أهم ضوابط الرقابة الفعالة على الأسواق والتدخل الجماعى للحد من الارتفاع المغالى فيه للأسعار.
المطروح هنا ليس مجرد سياسة حكومية جديدة لتشجيع دخول صغار صغار المنتجين والموزعين حلبة المنافسة، وإنما اعادة نظر فى تفكير المجتمع عموما بشأن أدوات الدولة فى ضبط الأسواق. الاقتصاد المصرى حاليا مما بنطبق عليه وصف «الاقتصاد المختلط»، وهذا فى حد ذاته لا بأس به إن كان ينتهج سياسات متسقة مع نفسها ويستخدم أدوات فعالة لتحقيق أهداف التنمية المرجوة.
ولكن الواقع أننا فى هذا الموضوع واقعين فى تناقض مستمر بين الاعتقاد بقدرة الدولة على ضبط الأسواق بالوسائل التقليدية التى لم تعد فى الحقيقة مجدية، وبين الاقتناع بأن فتح باب المنافسة مفيد للمواطنين وللاقتصاد القومى وليس فقط للشركات الكبرى ولأصحاب المصالح. والى أن نحسم رؤيتنا لهذا الأمر فإن المواطن سيظل غير مستفيد لا برقابة فعالة من الدولة ولا بمنافسة حرة تحارب الاحتكارات القائمة.