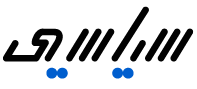رغم الموارد الضخمة .. لماذا بقي السودان فقيراً حتى يومنا هذا؟

منذ عام 1999 ولعقد من الزمان، شهد الاقتصاد في السودان ازدهاراً ملحوظاً بفضل دخول النفط كموردٍ سريع العوائد لميزانية البلاد.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد زاد، في ظل تنامي الإنتاج الذي واكب ارتفاع الطلب العالمي وزيادة أسعار النفط عالمياً، ونتيجة لذلك تدفّقت الاستثمارات الأجنبية، وبدأ السودان يحقّق معدّلات نمو عالية.
لكن الحكومة السودانية لم تحقّق الفائدة المرجوّة من هذه الظروف في تطوير قطاعاتها الإنتاجية الأخرى؛ سواء ما يتصل بثروتها الحيوانية أو قدراتها الزراعية التي تعتبر المستقبل الحقيقي للبلاد.
ومنذ انفصال الجنوب في 2011، والذي كان يمتلك معظم الحقول النفطية المنتجة، والتي استثمرت فيها الحكومة أموالاً مقدّرة، ظلّ الاقتصاد السوداني يواجه العديد من المشاكل، التي فاقمتها الصراعات والحروب الداخلية والعقوبات الأمريكية.
في إطار بحثها عن حلول عمليّة لأزمتها، سعت الخرطوم إلى رفع أو تخفيف العقوبات الأمريكية الاقتصادية والتجارية المفروضة عليها منذ أكثر من 20 عاماً، فانخرطت في تحالف عاصفة الحزم لتأكيد هويّتها السنّية والبحث عن المصالح المشتركة والمساندة الاقتصادية.
ثم اتّجهت نحو تعزيز علاقاتها مع موسكو بالتوصّل إلى تفاهمات عسكرية وسياسية واقتصادية تعود عليها بنتائج ايجابية في سبيل تجاوز حالة الأزمة الاقتصادية وتقوية موقفها التفاوضي مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكذلك اتّجهت نحو تعزيز علاقاتها مع أنقرة، التي حظيت بامتيازات في ميناء سواكن على البحر الأحمر، إذ وقّع الطرفان 22 اتفاقية، وأعلنا عزمهما خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، أواخر ديسمبر الماضي، زيادة حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.
هذا، وانتهجت سياسة محايدة إزاء الأزمة الخليجية التي فجّرتها دول الحصار ضد قطر، ولم تَمِلْ تجاه أي طرف على حساب الآخر، على الرغم من الوعود السعودية الإماراتية السخية.
كما قادت الخرطوم جهود وساطة برعاية منظمة "إيفاد" لإنهاء الحرب الأهلية في دولة جنوب السودان الوليدة، تكلّلت بتوقيع الأطراف المتنازعة، في 27 يونيو، على اتفاق سلام أولي عُرف بإعلان الخرطوم السياسي.
فمن مصلحة السودان نجاح هذه المفاوضات تمهيداً لإعادة تأهيل اقتصاد الجنوب حتى تتمكّن الخرطوم من الاستفادة من العلاقات التجارية الثنائية مع الجنوب، خاصة ما يتعلّق بالتعاون في مجال النفط.
لكن كل هذه التحرّكات لم تتمخَّض عنها نتائج إيحابية طويلة الأجل فيما يتعلَّق بهذه الأزمة حتى الآن، فالعقوبات الأمريكية لا تزال تحول دون الوصول إلى تطبيع كامل مع مؤسَّسات التمويل الدولية.
كما أنها تقف عارضاً أمام تجاوز البلاد صعوبات في التعاملات مع البنوك الخارجية، وأقصى ما تحقَّق لا يخرج عن كونه حلولاً جزئية.
أين الخلل؟
يُرجع العديد من خبراء الاقتصاد بروز هذه الأزمة الاقتصادية التي أصابت الاقتصاد السوداني إلى سببين؛ الأول هو انتهاج سياسة تحرير الاقتصاد، والثاني هو التضخُّم الذي نتج عن طباعة العملة لتغطية الفجوة الحادَّة في النقد، فبلغ معدّله 52,37%.
المتخصّص في الاقتصاد السياسي، عبده مختار، يقول إن جوهر الأزمة الاقتصادية في السودان سياسي، ويكمن في فشل الحكومة في إدارة موارد البلد وإدارة التنوّع.
فالسودان من أغنى دول العالم من حيث الموارد، خاصة بعد اكتشاف النفط والذهب خلال العقدين الماضيين، وفيه أرض شاسعة خصبة صالحة للزراعة (200 مليون فدان مربع)، وثروة حيوانية (أكثر من 150 مليون رأس).
وفيه 12 نهراً، وأمطار غزيرة، وتنوّع مناخي ومحصولي، وموارد بشرية وطبيعية أخرى تؤهّله لأن يعيش شعبه في رفاهية.
ويقول مختار: إن "توهان العقل السياسي في المصالح الحزبية والذاتية، والفساد والإقصاء والظلم، وغياب دولة القانون، جعل السودان دولة فقيرة تستجدي المنح والقروض والمعونات".
أما الكاتب الصحفي محمد عبد العزيز، فيرى أن الأزمة نتاج عدد من الأسباب؛ أبرزها عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي الناتج عن التوسّع المستمرّ عبر الموازنة العامة للدولة في الإنفاق الحكومي التشغيلي غير الداعم للنموّ.
وهذ الأخير زاد بأكثر من 100% منذ انفصال الجنوب، وذهاب 75% من إنتاج النفط إليه، بجانب الصرف خارج الموازنة على الجوانب العسكرية والأمنيّة.
واعتبر أن "الحكومة السودانية لم تتكيَّف مع انفصال الجنوب بالشكل المطلوب (في يوليو 2011)"، بحسب عبد العزيز.
ويقول: "العامل الثاني للأزمة يرتبط بالتراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية؛ الزراعة والصناعة، خلال الأعوام الثمانية الماضية، التي شهدت نمواً سلبياً بلغ متوسط معدله السنوي نحو 3%".
وهذا، بحسب الصحفي السوداني، أدّى إلى ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج المحلّي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلّصت من حجم الصادرات، ما أدّى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، ثم تنامي عجز الميزان التجاري الذي ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2011، إلى نحو 6 مليارات في عام 2018.
وبالنسبة إلى مختار، فإن النزاعات الداخلية في دارفور (جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق) أدّت إلى زيادة الصرف على الأمن والجيش والشرطة، ما استنزف الموازنة (أكثر من 70% منها يذهب للأمن)، أضف إلى ذلك أن النزاعات والاضطرابات أدّت إلى توقّف مشروعات التنمية وعصفت بالاستثمار الوطني والأجنبي.
البدائل والحلول
الكاتب عبد العزيز يقترح عدداً من البدائل؛ يتمثّل أوّلها في العمل على جذب تحويلات المغتربين، التي تقدَّر بنحو 6 - 8 مليارات دولار، وتحفيزهم لتحويل مدَّخراتهم عبر القنوات الرسمية.
الأمر الثاني إنشاء بورصة للذهب والمعادن بدل أن يحتكر بنك السودان شراء الذهب الذي ينطوي على آثار تضخّمية كبيرة بسبب ما يضخّه البنك من كتلة نقدية.
وبذلك، يقول عبد العزيز، يوفّر السودان ما يقدَّر بنحو 10- 12 مليار دولار سنوياً، ما يعني الإبقاء على عجز الميزان التجاري في حدود 5 مليارات دولار فقط.
ويتابع حديثه عن الأمر الثالث الذي يتمثَّل في ترشيد الإنفاق الحكومي، وهذا ما لم يتحقَّق طوال السنوات الماضية. وأما رابعاً فالأمر متعلّق بمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، دون أن ينحصر في التعدّي على المال العام فقط، بل يجب أن يشمل كل ما يتصل بتعطيل الاستثمارات والإضرار بالبيئة الاقتصادية.
إن الأزمة التي يشهدها السودان، وإن بدت تجلياتها ذات أبعاد اقتصادية، فإن أصلها سياسي.
ولذلك ليس أمام الحكومة سوى الاتجاه لوضع سياسات تكفل زيادة الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية التي تدرّ العملات الصعبة لمعالجة الخلل بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
كما أنها مطالبة بالبحث عن فتح أسواق جديدة لصادرات الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، وزيادة علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، وتأسيس علاقات خارجية متوازنة تحقّق مصالح البلاد.
ولا بد من العمل في ذات الوقت على اتّخاذ إجراءات تُزيل معوّقات الإنتاج الصناعي والزراعي، وإيقاف الجبايات المتعدّدة، ومنع التهريب، ومحاربة الفساد والمفسدين، وضبط الصرف الحكومي.